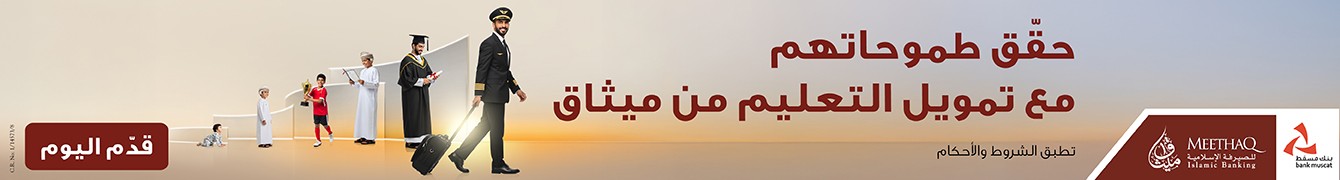خالد بن حمد الرواحي
خلف كل خدمة مُتعثرة، ومُوظف فقد حماسه، وميزانية تتبخر… هناك رجل يجلس في المقعد الخطأ.
في مؤسسات كثيرة تبدأ الحكاية بمدير جديد يدخل مكتبه وسط آمال مُعلّقة وابتسامات موظفين ينتظرون قرارات تنقلهم إلى الأمام. لكن سرعان ما ينكشف الواقع: مشاريع تتعثر، خطط تتلاشى، وطاقات بشرية تُستنزف بلا جدوى. لم يكن الخلل في المال ولا في الإمكانات، بل في قرار يتكرر مرارًا: وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب.
المناصب ليست كراسيَ فاخرةً ولا أوسمة تُعلَّق على الأبواب؛ بل مسؤوليات ترسم مصير مؤسسات وموظفيها ومجتمعات بأكملها. المدير الكفء يحوّل صلاحياته إلى طاقة مُلهمة، ويصنع من أبسط الموارد إنجازات ملموسة، بينما المدير غير المناسب يُطفئ الحماس ويقود المؤسسة نحو الارتباك.
ولا يقف الأمر عند حدود المكتب؛ فكم من موظف وجد نفسه عالقًا في اجتماعات طويلة بلا جدوى، أو في مُواجهة إجراءات معقدة لإنجاز عمل كان يمكن إتمامه في دقائق معدودة! مثل هذه الممارسات لا تُهدر الوقت فقط؛ بل تُحبط الموظفين وتسرق منهم شغفهم، لينعكس ذلك في النهاية على المواطن الذي ينتظر خدمة عامة ذات جودة عالية، فلا تصله إلّا بطيئة ومتعثرة، ضحية قرارات مرتجلة.
ومع ذلك، فالصورة ليست دائمًا قاتمة. فقد نجح بعض المسؤولين رغم أنَّهم لم يكونوا متخصصين، بفضل إدراكهم لنقص خبرتهم ورغبتهم الصادقة في التعلّم.
يروي أحد الذين انتقلوا من المجال الأكاديمي إلى موقع قيادي تجربته قائلًا: «جلست ستة أشهر كاملة لم أتخذ خلالها أي قرار؛ بل كنت أتعلم وأستمع وأستفيد من زملائي. وبعد أن فهمت طبيعة العمل، بدأت أمارس صلاحياتي بثقة». هذه التجربة تُبرهن أنَّ التواضع والانفتاح على التعلّم قد يعوضان نقص الخبرة، لكنها تبقى استثناءً نادرًا لا يمكن الركون إليه كقاعدة.
ومن زاوية أخرى، فإنَّ التخصص العميق وحده، على أهميته وقيمته، لا يكفي لصنع قائد ناجح. فالعالم الأكاديمي قد يكون بارعًا في مجاله الدقيق، لكنه يحتاج إلى مهارات أوسع حين يتولى موقع القيادة، إذ لا تُقاس القيادة بكمية المعرفة في حقل واحد، بل بقدرة صاحبها على رؤية الصورة الكاملة، واستيعاب مختلف الزوايا، وتوظيف خبرات الآخرين لتحقيق الأهداف.
ولهذا فإنَّ التخصص العلمي، على أهميته، لا يغني عن الخبرة العملية التي تُكسب القائد القدرة على التعامل مع المواقف المُتغيرة، وصناعة القرار في الوقت المناسب. فالقائد الناجح هو من يجمع بين عمق المعرفة وسعة الخبرة.
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يصل غير المؤهلين أصلًا إلى تلك المناصب الحساسة؟ يقدّم الفكر الإداري جوابًا معروفًا يُسمى «مبدأ بيتر»، الذي يوضح أنَّ الموظف يُرقّى غالبًا استنادًا إلى نجاحه في موقعه السابق، حتى يبلغ منصبًا لا يمتلك فيه الخبرة اللازمة. ومن هنا يبدأ الخلل، ليدفع ثمنه الموظفون أولًا، ثم المؤسسة بأكملها.
ولا يقتصر الأمر على ما يشرحه الفكر الإداري عبر "مبدأ بيتر"؛ بل قد تتدخل أحيانًا عوامل غير موضوعية كالمُحاباة أو العلاقات الشخصية، فتُفسح الطريق لشخص قد لا يكون الأفضل مُقارنة بغيره، على حساب الكفاءات الحقيقية.
وهذا يُعد شكلًا من أشكال الفساد الإداري، ويتعارض مع قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح؛ إذ يمنح امتيازات لغير مُستحِق، ليحصل على مسمى وظيفي ودرجة مالية وراتب أعلى، بينما هناك من هو أكفأ وأجدر منه. وهنا تبرز أهمية قيام الجهات الرقابية بدورها للحد من هذه الممارسات وضمان عدالة الاختيار، فالمصلحة العامة للوطن يجب أن تُقدَّم على المصالح الشخصية والعلاقات.
وثمنُ وضع غير المناسب في موقع القيادة لا يُقاسُ بتعثُّر مشروع أو تبديد ميزانية فحسب؛ بل يظهر في فقدان ثقة الموظفين، وإحباط فرق العمل، وتبديد الطاقات، وارتباك المواطن الذي كان ينتظر خدمة عامة تليق بتطلعاته، فإذا بها تتأخر وتتعثر بسبب قرارات خاطئة. وكم هو مُحبِط أن يتصدر المشهد صاحب التجربة القصيرة، بينما يجلس أصحاب الخبرة الطويلة من الكفاءات على مقاعد الانتظار، يرون جهد السنين يتبخر أمام أعينهم.
وما يزيد الأمر خطورة أن غياب الأسس الصحيحة في الاختيار لا يوقف عجلة التطوير فحسب؛ بل يكرّس عجز المؤسسات عن التجديد. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الوظائف المستحدثة؛ بل بقدرة المؤسسات على إعداد قيادات تحمل الراية بكفاءة واقتدار، وتعمل بروح الفريق، فتقود العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ولأنَّ المشكلة في جوهرها لا تكمن في ندرة الكفاءات؛ بل في معايير الاختيار، فإنَّ التمسك بالقيم والمعايير الصحيحة يصبح ضرورة لا خيارًا. وهذه المعايير واضحة لكل من أراد المصلحة العامة: كفاءة مهنية، خبرة متعمقة، مؤهل علمي يرتبط بالوظيفة، وشخصية قيادية متوازنة تجمع بين النزاهة والأمانة- وهما قيمتان متجذرتان في الثقافة العُمانية- وبين الحزم والقدرة على اتخاذ القرار؛ فالقوة بلا نزاهة استبداد، والنزاهة بلا قوة ضعف، أما إذا غابتا معًا فالخطر مؤكد والمصيبة أعظم.
ومن هنا، فإنَّ الحلول لا بُد أن تكون عملية وواقعية: معايير شفافة تقوم على الكفاءة والخبرة، ولجان تقييم مستقلة تُقيّم المرشحين بموضوعية، وبرامج لإعداد القيادات الشابة وتأهيلهم مبكرًا لتحمل المسؤولية. فبهذه الإجراءات تُبنى الثقة، ويُصان المال العام، وتُفتح الأبواب أمام الكفاءات العُمانية الشابة التي يُعوَّل عليها للنهوض بالمؤسسات.
فالخطأ في التعيين لا يقتصر أثره على مكتب بعينه؛ بل يمتد ليصيب المؤسسة بأكملها: موارد تُهدر، وطاقات تُحبط، وثقة مجتمع تتزعزع. وحين تتكرر هذه المفارقات، يصبح كل شيء مقلوبًا: من لا يعرف يُقرر، ومن يعرف يُقصى، فتفقد المؤسسة بوصلتها، ويضيع معها اتجاه التطوير والإصلاح.
أما حين يوضع الرجل المناسب في مكانه، فإن المعادلة تتغير كليًا؛ ترتفع المعنويات، وتتسارع الإنجازات، وتتحول التحديات إلى فرص واعدة. ونجاح المؤسسات هو نجاح الوطن، فالأوطان لا تُبنى بالشعارات؛ بل بكفاءة أبنائها الذين يستحقون أن يمنحوا الثقة، لتظل مؤسساتنا قوية، ويعلو بها الوطن إلى المكانة التي تليق به.
ضعوا الرجل المناسب في مكانه، فإمَّا أن تنهض المؤسسات ويعلو الوطن، أو نستمر جميعًا في دفع فاتورة الأخطاء!